الشتات الحلقة الثانية عشر " وبدأت عجلة الحياة تدور "

منذ بدء العمل في إقامة المخيم، قامت الجهات المسئولة في وكالة الغوث بفتح مدرستين، واحدة للأولاد والأخرى للبنات، ما جعل بإمكان كل رجل أو امرأة لديها بعض التعليم أن تلتحق بالسلك التدريسي. لكن قبل وصول وكالة الغوث، كانت جمعية الشبان المسيحيين قد فتحت مدرسة للأولاد في المخيم، وأصلحت جزءاً من الأرض ليكون ملعباً لكرة القدم، أشرف عليه الأستاذ حسين الأمريكاني. وحال بدء الدراسة في أوائل عام 1950 كنت من أوائل التلاميذ الذين التحقوا بالمدرسة بعد تغيب قارب السنتين. أدخلوني في الصف الثالث الابتدائي، وبدأنا نتلقى الدروس في خيمة واسعة جالسين على أرض مغطاة بحصيرة مصنوعة من عيدان البوص. كان أهل قرية العباسية قد تخصصوا في صناعة ذلك النوع من الحصير، وعاشت عائلات كثيرة منهم على تصنيعه وبيعه لسنوات، ما جعل أحوالهم المعيشية تتحسن بسرعة بالنسبة لغيرهم من اللاجئين. لكن خيمة الصف الثالث ضاقت بمن فيها بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر بسبب ازدياد أعداد المنتسبين من الأولاد، ما اضطر الإدارة إلى "ترفيع"، أي نقل عشرة تلاميذ من الصف الثالث إلى الصف الرابع. وبسبب أدائي الجيد، خاصة في مادة الرياضيات، كنت أحد أولئك التلاميذ الذين رُفعوا للصف الرابع في منتصف الطريق.
بعد مضي ثلاثة أشهر أخرى، قامت إدارة المدرسة بإجراء امتحان عام لكافة التلاميذ، وترفيع الناجحين منهم إلى صفوف أعلى. ولقد جاء ذلك القرار في محاولة لتعويض الصبية عما فاتهم من وقت بسبب حالة التشرد وانعدام المدارس، ومن أجل التأكد من وصول كل تلميذ إلى المستوى التعليمي الذي يتناسب مع معارفه وسنه. ومن بين التلاميذ العشرة الذين رُفعوا للصف الرابع في منتصف الطريق، لم ينجح في الامتحان سوى تلميذ واحد فقط... نعم... كنت ذلك التلميذ الذي نجح بجدارة أكسبتني ثقة كبيرة بالنفس، ودفعتني، مع تزايد توقعات الأهل والأصدقاء والأساتذة، إلى العمل الجاد والحفاظ على المركز الأول في صفي في معظم سنوات الدراسة في مدرستي عقبة جبر وبعدها في مدرسة هشام بن عبد الملك في أريحا. وبسبب تطبيق تلك السياسة، سمحت لي الظروف، دون غيري من الزملاء، بإكمال الصفوف الثالث والرابع والخامس في سنة واحدة، ما جعلني أغدو أصغر تلامذة صفي عمراً، ومن أصغرهم حجماً، ولكن أكثرهم تقدماً من الناحية الدراسية، وهذا منحني المزيد من الثقة بالنفس لاقتحام مجال القيادة الطلابية في كل المدارس والجامعات التي درست فيها لاحقاً. وبعد نجاحي الباهر في الصف الخامس الإبتدائي وحصولي على المرتبة الأولى في الصف، أهداني الوالد ساعة الأوميجا التي ضاعت في ليلة معتمة كما أشرت سابقاً. بعد وصول وكالة غوث اللاجئين انتقلت المدارس وعملية الإشراف عليها لرجال الوكالة، ما جعل العملية التعليمية تصبح عملية مؤسسية ذات أنظمة وقواعد ومناهج واضحة اتبعت نظام التعليم في الأردن.
من ناحية أخرى، قامت وكالة غوث اللاجئين مع افتتاح المدارس بفتح عيادة طبية ذات إمكانيات فنية ضعيفة للغاية، لم تتعد طاولة فحص صغيرة وسماعة وجهاز بدائي لقياس درجة حرارة المريض، وآخر لقياس ضغط دمه. أما مدير تلك العيادة والطبيب العامل فيها فقد كان رجلاً مصرياً كبير السن اسمه "صليبا"، يتصف بالبدانة النسبية، ولكن بالطيبة المفرطة والحرص على طمأنة مرضاه مهما كانت خطورة أمراضهم، يساعده موظف أو ممرض من أقاربنا اسمه محمود أبو ناموس، لم تكن لديه أية خبرة في التمريض. وبسبب قلة الأدوية وضعف تنوعها، كان الطبيب يقول كلما خرج من غرفته مريض من المرضى بعد الكشف عنه، "أديلو حبتين يا محمود". كانت الحبوب الوحيدة المتوفرة بشكل دائم هي حبوب الأسبرين وكبسولات المضادات الحيوية. وبسبب الأوضاع المعيشية المزرية في المخيم، كانت الحالة الصحية لعامة السكان سيئة، لكنها لم تكن كارثيه على الرغم من عدم توفر النظافة في الأماكن العامة وعدم وجود مرافق صحية غير المراحيض. ويعود السبب الرئيسي لقلة الأمراض وعدم تفشيها بين الناس إلى جفاف الجو وارتفاع درجة الحرارة ونقاء الماء من ناحية، وتوفر بعض الأغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات كالحليب الجاف والبيض المجفف وزيت السمك والسردين من ناحية ثانية، وثقافة النظافة التي تربى عليها غالبية أبناء فلسطين في بيوتهم. إضافة إلى ذلك، دأب المسئولون عن الصحة العامة على استخدام المبيدات الحشرية في النظافة، ورش رؤوس التلاميذ بين الحين والآخر بمسحوق أل DDT، وهو مركب كيماوي استخدم في القضاء على القمل وغيره من حشرات تقوم بنشر الأمراض المعدية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منظمة الصحية العالمية اكتشفت بعد حين أن مخاطر ذلك المسحوق تزيد كثيراً عن فوائده، ما استدعى تحريم استخدامه دولياً.
منذ وصولنا إلى عقبة جبر، وحال استقرارنا هناك، قام الوالد بتوزيع الأعمال والمهام على أفراد أسرته. كان نصيبي وأختي الكبرى يُسرى، التحطيب والتعشيب، أي جمع الحطب والبحث عن أعشاب برية صالحة للأكل. كنا ننطلق في الصباح الباكر نحو الصحراء الممتدة أمامنا على مدى النظر في اتجاه البحر الميت بحثاً عن مصادر وقود، أو نتجه نحو سفوح الجبال القريبة بحثاً عن أعشاب برية صالحة للطعام، منها الخبيزة والبقلة التي كنا نسميها "رجلة"، وغيرها من نباتات مألوفة. وحيث أننا وصلنا عقبة جبر في أواسط فصل الشتاء تقريبا، فإن عملنا توزع بين التحطيب والتعشيب، وذلك لأننا كنا بحاجة لمصدر وقود وآخر للطعام في ذات الوقت. ومع توالي الأيام والأسابيع، لم تعد المنطقة المجاورة قادرة على إمداد السكان بحاجتهم من الوقود أو من الخضار البرية، ما جعل عملنا يغدو مرهقاً، ويوم عملنا شاقاً وطويلاً، كان يمتد أحياناً من الصباح حتى مغيب الشمس دون طعام أو شراب. كانت سلسلة الجبال التي ترتفع تدريجياً من منطقة أريحا وصولاً إلى القدس والقرى المحيطة برام الله تحد عقبة جبر من الغرب والشمال الغربي، فيما كانت الصحراء التي تمتد حتى البحر الميت ونهر الأردن تحدها من الشرق والجنوب الشرقي، وإلى الشمال، على بُعد اربعة كيلومترات تقريباً، كانت هناك واحة خضراء صغيرة وهادئة، اسمها أريحا.
إن حب الفلسطينيين للخضار والأعشاب البرية، خاصة أبناء الساحل منهم، قد لا يوازيه حب شعب آخر. كانت والدتي تُعدُ نفس النوع من الخضار بأكثر من طريقة، ما جعل بالإمكان تنويع الطعام دون تغيير المواد الغذائية. وعلى سبيل المثال، كانت تعد الخبيزة بطريقتين، إما بطبخ الأوراق مع بعض العجين الذي كانت تصنعه على شكل حبات صغيرة مدورة كما يُصنع الكسكسي الذي يسميه الفلسطينيون "مفتول"، أو بطبخ فروع النبات بما عليها من أوراق "مُعصرة". كنت أحب النوع الأول وما زلت اشتهيه، واطلب من أختي رهيفه أن تطبخه لي كلما زرتها في عمان في فصل الشتاء، لنأكله معاً مخلوطاً بالفلفل الأحمر الحار الذي تعده بنفسها. ومع تجاوز غالبية اللاجئين الفلسطينيين محنة الفقر والحاجة وحياة المخيمات البائسة، إلا أن علاقتهم بالخضار لم تنته وحبهم لها لم يضعف. وهذا كان سبباً في شيوع نكتة في الأردن تقول بأن شاباً أردنياً من أصول بدوية تزوج فتاة فلسطينية تربت على حب الخضار والفواكه، ما جعلها تطبخ لزوجها في اليوم الأول ملوخية، وفي اليوم الثاني خبيزه، وفي اليوم الثالث بقلة. سألته في اليوم الرابع عما يريد أن تطبخ له من أنواع الخضار التي يشتهيها، قائلة هل تفضل الفاصوليا أم البامية؟ وهنا أجابها الزوج الذي تربى على لحم الأغنام والخراف والمناسف بالسمن البلدي، لا أريد أن أزعجك بالطبيخ اليوم، سأذهب إلى البر وارعى مع الغنم.
أثناء تجوالنا في الصحراء بحثاً عن ورق الشجر والأغصان كمصدر وقود، كنا كثيراً ما نصادف أرانب برية مختبئة في حضن شجيرات صحراوية... كانت تلك الأرانب تُرعبنا حين تقفز أمامنا فجأة هاربة منا. وأحياناً، كنا نصادف طيوراً صحراوية مثل البط والنعام وغيرها وقد بنت لها أعشاشاً في حضن شجيرات كبيرة نسبياً كنا بأمس الحاجة إليها. إلا أن عشقي للطيور عامة وتعاطفي معها وتعلقي بها، كان يمنعني من اقتلاع الشجيرات التي تسكنها. كنت انتظر بفارغ الصبر قدوم الأسبوع التالي لأتفقد تلك الأعشاش، لكن أملي كان يخيب في كل مرة، إما لأننا كنا نضل طريقنا في صحراء واسعة بلا معالم، أو لأن غيرنا من الصبية اهتدوا إليها في غيابنا وقاموا باقتلاع الشجيرات ومصادرة البيض. وأحياناً كنا نقتلع شجيرة مسكينة من جذورها لنجد تحتها أفعى تأخذ غفوة قبل مواصلة البحث عن فريسة تلتهمها. وفيما كانت غالبية الشجيرات المنتشرة في الصحراء قد اتخذتها الأفاعي حدائق تتظلل بظلالها، كانت معظم الحجارة الكبيرة تخفي تحتها أوكاراً غنية بكل أنواع العقارب الصغيرة والكبيرة، ومنها ما تسبب في قتل الصغار والكبار من أبناء المخيم.
بعد أسابيع لم تطل كثيراً، لم يعد بإمكاننا أن نجد حاجتنا من الحطب، حتى وإن سرنا حتى أطراف البحر الميت، حيث تنتهي حياة النبات عند بدايات مستنقعات الملح. كان سكان المخيم قد جمعوا ما كان متوفراً من الأخشاب واقتلعوا ما كان موجوداً من النباتات، ولم يعد هناك مصدر لأوراق أو أغصان كافية لإشعال نار بإمكانها طبخ طبق طعام أو حتى رغيف خبز. لكن مع نفاد مصادر الوقود المستمدة من الأخشاب والأشجار والأعشاب، كان لا بد من إيجاد مصدر بديل ووسائل طبخ مختلفة. وهنا بدأ تجار الجملة يستوردون "الكاز" من المدن القريبة والبعيدة، وبدأ الناس في شراء "بوابير" الكاز واستخدامها على نطاق واسع في عمليات الطبخ وإعداد الشاي والقهوة وتسخين الماء وغير ذلك من عمليات منزلية. ومما ساعد على تنشيط الحياة الاقتصادية والحركة التجارية في المخيم، تزايد النشاط الزراعي في أريحا، وبدء حركة هجرة نشطة من أبناء فلسطين إلى الكويت وغيرها من بلاد المهجر العربية والأجنبية، وقيام هؤلاء بمساعدة ذويهم مالياً، خاصة المقيمين منهم في مخيمات لاجئين في منطقة أريحا وعمان.
إن حالة الفقر وانعدام الكهرباء في المخيم اضطرت الطلبة للقيام بحل مسائل الرياضيات والهندسة وغيرها من واجبات مدرسية منبطحين على الأرض... كنا نتجمع في أحد البيوت ونقوم باستكمال واجباتنا الدراسية. أما عمليات مراجعة الدروس والاستعداد للامتحانات فكانت تتم غالباً في الخلاء، إما في المناطق الصحراوية الواقعة شرقي المخيم، أو على سفوح الجبال شبه القاحلة التي تحد المخيم من الغرب، وأحياناً تحت لمبات الشوارع العامة التي كانت تبدو دوما شبه معتمة. حاول الزميلان محمد نوفل ومحمد أبو عيد مراراً إغرائي بتعلم التدخين أثناء التجول في الصحراء وعلى سفوح الجبال، إلا أنني رفضت بشدة وعشت حياتي كلها من دون سيجارة واحدة، لكنهم نجحوا في إغراء نمر أبو زينة، حيث قاموا بشراء السجاير له وإقناعه بالاستلقاء على ظهره وممارسة عملية الشهيق والزفير مع كل نفحة للتأكد من دخول الدخان إلى رئتيه. ومع توارد الأيام واستمرار التدخين، تعود نمر على السيجارة وانضم من حيث لا يدري لجماعة المدخنين المدمنين.
لم يكن التدخين في الواقع الشيء السيئ الوحيد الذي تعلمه ومارسه بعض الأصدقاء من أبناء مخيم عقبة جبر في حينه، إذ اهتدى البعض الآخر منهم إلى شرب الكحول والوصول إلى درجة السكر والعربدة أحياناً. ففي يوم من الأيام، قام اثنان من أصدقائي من أبناء عقبة جبر بشراء زجاجة ويسكي من أريحا واحتساء كميات كبيرة منها، ما أسكرهم وجعلهم يفقدون السيطرة على أنفسهم. وصلت إلى مكان الحادث على غير موعد، ومن دون أن يكون لدي علم مسبق بما كان يجري، وهناك وجدت أحدهم يمسك بعنق نمر زينة وفي يده سكين، يهدده بالقتل ويُخيره بين قطع يده أو قطع رجله، فيما كان الآخر يترنح ويهذي مُمسكا بزجاجة الويسكي في يده ولم يكن قد بقي فيها شيء تقريبا. تحايلت على الأول حتى أخذت السكين من يده وحررت نمر الذي ولي هارباً بسرعة إلى بيته. قمت بعدها بالتحايل على الصديق الآخر حتى أخذت منه زجاجة الويسكي، وبالتعاون مع عبد الرحمن عرار قمنا بمساعدة الأصدقاء والبقاء إلى جانبهم حتى استعاد كل منهما وعيه، ومن ثم أوصلناهم إلى بيوتهم بعد أن كانت بقية عائلاتهم قد نامت. كان والد أحدهما متزمتاً وقاسياً جداً، لم يكن ليتردد لحظة واحدة في قتل ابنه لو رآه على مثل تلك الحالة من السكر. ما يزال أحد أولئك الأصدقاء يتعاطى الخمر ويدخن حتى يومنا هذا، فيما تحول الآخر بعد انتسابه لحزب التحرير الإسلامي إلى رجل شبه متزمت دينياً واجتماعياً، وما زلت التقي بهما كلما زرت عمان.
ذهبت في أحد الأيام مع بعض الزملاء للدراسة على سفح إحدى الهضاب الجبلية المطلة على المخيم. وفيما كنا جالسين بجانب صخرة نتظلل بظلها من الحر، نقرأ ونُخَزِن المعلومات في رؤوسنا كما يُخزنها أبناؤنا في حواسيبهم، مرً بنا شابان يركب أحدهما حماراً اكتشفنا لاحقاً أنها أنثى، فيما كان الثاني يسير خلفه. لم يلاحظ الشابان وجودنا، توقفا على بعد أمتار من المكان الذي كنا نجلس فيه، ثم قام الشاب الذي كان يركب الحمارة بممارسة الجنس معها، طبعا دون استشارتها، فالأنثى في عُرف غالبية العرب لا تُستشار في مثل تلك الأمور، ولا يحرص الذكر كثيراً على استثارتها قبل ممارسة الجنس معها. قام ذلك الشاب بإنزال بنطلونه... أمر زميله بأن يمسك بذنب الحمارة ويزيحه بعيداً عن مؤخرتها، ثم قام بممارسة الجنس معها. وقفت الحمارة بهدوء، لم يبدو عليها الشعور بالتهيج كما هي عادتها حين ترى حماراً يروق لها منظره وتكون مستعدة لمضاجعته، ولذا لم تفتح رجليها كعادتها في مثل تلك المواقف... كانت على ما يبدو تشعر بحب استطلاع وليس بشهوة، تنتظر ماذا ستفعل تلك الدودة الصغيرة الحقيرة التي تسربت إلى مؤخرتها. تذكرت تلك الحادثة بعد أعوام، وهناك أدركت معنى الحرمان ومدى قسوته، وكيف أن بإمكانه أن يحول إنساناً عادياً يتصف بالجهل إلى حيوان لا يتورع عن الاعتداء على الغير اشباعاً لشهوات وغرائز قد تُشعره فيما بعد باحتقار نفسه لزمن طويل.
كان نمر زينة ومحمد أبو عيد، وهما أبناء عمومة من أبوين غير شقيقين، يعيشان على طرف واد كبير وعميق نوعاً ما، يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من المخيم، استعملته إدارة المخيم مكاناً لتجميع الزبالة والنفايات والقيام بحرقها، لذا كانا يقولان حين يسألهما سائل عن مكان سكنهما بأنهما يسكنان في شارع المحرقة، أي محرقة الزبالة. بعد سنوات عديدة من انتقال عائلتي أبو زينة وأبو عيد إلى عمان، توفي نمر بعد إصابته بمرض عقلي، وتوفي محمد أبو عيد بمرض السرطان قبل أن يكمل أيهما الخمسين من عمره. حزنت كثيراً لفقدانهما، تذكرت حينئذ شارع المحرقة والمزبلة والخندق ودخان النفايات المحترقة يغطي بيوت محمد أبو عيد ونمر زينة طوال ساعات الليل والنهار تقريبا. وهنا تساءلت عما إذا كان دخان المحرقة وتدخين السجاير قد لعبا دوراً في موتهما قبل الأوان، وبالطريقة المؤسفة التي ماتا بها.
حاول اللاجئون من كل قرية أو مدينة أو عشيرة التجمع في جانب من جوانب المخيم، يعاودون فيه حياة انتهت ولكن ما يزال الحنين إليها حياً وقوياً. وكغيرهم من لاجئين، قامت عائلات الغُربية التي سكنت يازور قبل وقوع النكبة بالتجمع في طرف المخيم والعودة لمزاولة أعمالهم وحرفهم التقليدية. الغُربية هو لقب أطلق على الغرباء من الناس الذين عاشوا حياتهم يتنقلون من مكان لآخر واحترفوا أعمالاً غير زراعية تركزت حول تصنيع أدوات الأكل كالملاعق والشوك والسكاكين وأواني الطبخ النحاسية وطناجر الغسيل، والأدوات الزراعية التي تحتاج لحدادة كالمناشير والفؤوس والمقصات الكبيرة والصغيرة التي كانت تُستخدم في تقنيب أغصان الشجر والورود، ومقصات تقطيع القماش والحلاقة وغير ذلك من أدوات مشابهة، كما عاودوا أيضاً أعمال تنظيف الأدوات المصنوعة من النحاس والفضة وتلميعها. وبسبب خبرة جمعة أبو ربيع في السيارات وعمليات صيانتها وتصليحها، وجد نفسه، ولأكثر من سنة، يعيش بين أولئك الناس، يساعدونه ويساعدهم، يتعاونون في صيانة السيارات الخاصة وسيارات الشحن الكبيرة، وتصليح الأجزاء التي تحتاج لحدادة بسبب حوادث السير، والعيش على ما كانوا يحصلون عليه من دخل لقاء تلك الخدمات.
سمع والدي في يوم من الأيام صوت المُطَهِر يمر في الشارع أمام البيت، وكان الوالد على ما يبدو قد اتفق مع زوجته على تطهير أولاده في أقرب فرصة ممكنة. لذا أمرني باللحاق بالمطهر وإحضاره إلى البيت. كان المطهر يحمل حقيبة كبيرة الحجم نسبياً، قديمة جداً ذات لون بني كالح، تحوي في داخلها عدة مقصات ذات أحجام مختلفة، وأدوات حلاقة وبعض الشاش والكحول لتطهير الجروح، إلا أنه لم يكن لدى المطهر مضادات حيوية لمنع الالتهابات أو معالجتها. أخذ الوالد يتسامر مع المطهر حتى تجمع جميع الأولاد في البيت، ومن بينهم ابن عمي بسام الذي كان يزورنا في ذلك اليوم. بعدها بدأ المطهر عملياته الجراحية والعرق يتصبب من جبينه حتى انتهى من آخر ولد، بمن فيهم بسام الذي يعيش اليوم في السعودية ويعمل طبيب أطفال في مدينة جدة. لقد خضع بسام، أو بالأحرى أُخضع بسام البالغ من العمر حوالي سبع سنوات لعملية جراحية مع أولاد عمه رغماً عن إرادته، ومن دون علم والديه. لحسن الحظ، وبسبب عناية الوالدة الفائقة بنا واهتمامها غير العادي بالنظافة، لم تحدث مضاعفات تتسبب في مرض أي واحد من الأولاد.
وفي الواقع، ما كاد المخيم يتحول إلى قرية كبيرة مكتظة بالسكان حتى بدأت نشاطات التصنيع الصغيرة والخدمات العديدة تنتشر فيه بشكل ملحوظ، مثل صناعة الحصير والأحذية والملابس، وخدمات صالونات الحلاقة والدكاكين والمخابز، كما فُتحت أسواق للخضار واللحوم تبيع لحوم الخراف والأغنام والأبقار، وأحياناً لحوم الجمال والطيور كذلك. وفي مجال الترفيه عن النفس، انتشرت لعبة كرة القدم، وأقيمت المقاهي التي أصبحت بسرعة أمكنة للتجمع والتسلية ولقاء الأصدقاء، والتعارف بين الناس، وسماع آخر الأخبار السياسية والأغاني عبر أجهزة الراديو التي لم تكن متوفرة الا في المقاهي العامة. كان الراديو كبير الحجم، يعمل على بطارية يتم شحنها يومياً، وكثيراً ما كنا نضطر لتغيير مكاننا المعتاد والذهاب إلى مقهى آخر بسبب عدم وجود بطارية مشحونة في مقهانا المفضل. كان مقهى محمود الأغبش الذي ينتمي لقرية العباسية، هو المقهى المفضل بالنسبة لي ولغالبية أصدقائي وبعض أساتذة المدارس.
ومع عودة عجلة الحياة إلى الدوران بشكل شبه طبيعي، عاد الناس إلى التزاوج والتعاون في مشاريع تجارية ونشاطات اقتصادية. وفي ضوء تقارب الغرباء من خلال العيش جيرانا في مكان واحد، وتباعد الأقارب عن بعضهم البعض بسبب توزعهم على مخيمات في مناطق مختلفة، أصبحت معظم الزيجات تتم بين شباب وشابات من قرى ومدن مختلفة. ومن الزيجات التي تمت مبكراً في حينه، زواج السيد محمد عبد القادر أبو ناموس بابنة عم والدي، عمتي رقية. كان العبد أبو ربيع يحب محمد أبو ناموس كثيراً، ويحب ابنة عمه التي وهبها والدها له يوم ميلادها. إلا أن حبه لها وتقديره لمحمد أبو ناموس من ناحية، وحرصه على أولاده وزوجته التي تزوجها بعد قصة حب صعبة من ناحية ثانية، دفعه لإقناع صديقه وابنة عمه بالزواج. نعم... لقد عادت عجلة الحياة إلى الدوران، ما جعل مخيم عقبة جبر يفيض حيوية وقد بدا قبل سنتين يرقد على فراش الموت. لكن الحياة في المخيم كانت تتعرض بشكل استفزازي لقوى ضغط خارجية وإجراءات سلطوية أمنية حاولت تحطيم معنويات الناس وإذلالهم، ووأد طموحاتهم. كان مدير المخيم، السيد إبراهيم أبو الريش على سبيل المثال، يخرج من جحره كل ليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، يقف في وسط الساحة العمومية التي تحيط بها المقاهي من كل جانب، ويصفر عدة مرات معلناً انتهاء السهرة، وبداية ساعات منع التجول، وبالتالي يصدر أوامره بتوقف الحياة عن الحياة في مخيم بائس يكافح من أجل الإحساس بطعم الحياة.
كان السيد إبراهيم أبو الريش رجلاً بديناً قصير القامة، جلدته شقراء ووجهه يميل إلى الاحمرار يعلوه النمش، وعيناه صغيرتان تغطيها رموش صفراء بلون الذهب، أي كان "جينجي" كما يقول الفلسطينيون. وهذا جعل من الصعب على السيد أبو الريش الخروج في النهار من مكتبه والتعرض لنور الشمس وحرارة الجو. لذلك قام الآمر الناهي في مخيم عقبة جبر بجمع شلة سيئة من الزعران والبلطجية والقبضايات من حوله، والاحتفاظ بهم مرافقين له، واستخدامهم للتجسس على الناس والقيام بخدمات أخرى لحسابه الخاص لا تجيزها قوانين، ولا تسمح بها عادات أو تقاليد أو أعراف. ومن تلك الخدمات، تكليفهم بابتزاز الفقراء والضعفاء، حيث كان على سبيل المثال لا يعطي البسطاء من الناس قطع الخشب المخصصة لهم لبناء سقوف لمنازلهم من دون رشوة تدفع له من خلال أحد الزعران المحيطين به. في المقابل، تغاضى السيد أبو الريش عما كان يقوم به أولئك الأوباش من تصرفات مشينة، من بينها الاعتداء على الغير، واستباحة شرف العديد من نساء المخيم. إلا أنه كانت هناك شلة أخرى وقفت للمدير المستبد ولكل من كان حوله من زعران ومجرمين بالمرصاد، وحالت دون تماديهم في الاعتداء على الأبرياء واستغلال الضعفاء من أبناء عقبة جبر. كانت تلك الشلة التي تكونت بطريقة تلقائية عشوائية، والتقت حول أهداف إنسانية مشتركة تضم في عضويتها أكثر من عشرة شباب من أبناء قرى يازور وسلمه والعباسية.
يعتبر محمد أبو ناموس، أحد الأقرباء المقربين من العبد أبو ربيع وزوج ابنة عمه، من شباب يازور الذين اتصفوا بالشجاعة والمبادرة، وامتازوا بالذكاء والفطنة واللباقة. وفي ضوء ما كان يتمتع به من صفات قيادية، تمكن السيد أبو ناموس من الاستحواذ على مكانة اجتماعية مميزة في المخيم، ساعدته على تسلم منصب مدير بريد عقبة جبر حين تقرر فتح مكتب هناك. وفي يوم من الأيام، مررت على مكتبه كعادتي في طريقي من المدرسة إلى البيت، وعندها أخبرني أن لديه رسالة معنونة لخالي عبد العزيز بيرم، أعطاني الرسالة وطلب مني إيصالها للخال. وفيما كنا نجلس حول موقد نار لأن الجو كان بارداً في شتاء تلك السنة، ناولت الرسالة لخالي... نظر إليها طويلاً... تردد في فتحها... ناولها لي ثانية وطلب مني أن أفتحها وأقرأها له. كانت الرسالة من غزة، ومن خطيبته التي أحبها وقدم لها كل شيء لديه كي يقبل أهلها به ويوافقون على خطبته إليها. تقول الخطيبة في الرسالة إن أهلها أجبروها على قبول عريس آخر، وذلك بسبب تعذر وصولها إلي حيث يعيش خالي، وتعذر وصول خالي إليها. وبالفعل، بعد توقيع الدول العربية على اتفاقات الهدنة مع العدو الصهيوني في عام 1949، أصبح من المتعذر التواصل بين الفلسطينيين الذين عاشوا في الضفة الغربية والشرقية مع أهاليهم وأقاربهم الذين عاشوا في قطاع غزة أو في فلسطين المحتلة. ومع أن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن كان بإمكانهم السفر إلى سورية ولبنان والعراق ومصر، إلا أن السفر لم يكن سهلاً عليهم لعدم التعود عليه، ولأن تكاليفه كانت كبيرة وعواقبه غير مضمونة، كما وأن السفر من مصر إلى غزة بالذات لم يكن ممكناً في بادئ الأمر.
بعد أن سمع خالي ما جاء في الرسالة، أدرك أن حلمه الذي عاش من أجله تبخر فجأة، وأنه لم يعد هناك شيء يستحق أن يعيش من أجله. أخذ الرسالة مني، رمى بها في موقد النار، ثم خرج من البيت ولم يعد الا في اليوم الثاني وقد فقد سيطرته على ما كان يدور في رأسه من أفكار وخيالات. ومنذ تلك اللحظة، أخذ عبد العزيز بيرم يتكلم مع نفسه كلما وجد نفسه وحيداً، أو يتهامس مع من كان يتراءى له أنه يقف أمامه من خيالات وأشباح. كان يجلس أحياناً في زاوية بعيداً عنا ويضحك بلا سبب، يعتذر كلما لفتنا انتباهه لما كان يفعل، يخرج من البيت ويغيب ساعات طويلة دون طعام أو شراب. حاولنا علاجه بكل الطرق الممكنة، عرضناه على أطباء أمراض نفسية وعصبية في القدس وبيت لحم، وعلى منجمين وحجابين وبلهاء ومحتالين ودجالين وشيوخ في الضفتين الغربية والشرقية على السواء، وأخذناه إلى عديد مقامات الأولياء والصالحين والأنبياء، وقامت والدتي صبحه وخالتي صفية ووالدته فاطمة بالصلاة ليلاً ونهاراً والدعاء له واستجداء عطف السماء ورحمتها آلاف المرات من دون جدوى. ومع تتالي الأيام، استمرت حالته في التدهور، وأخذ وزنه في التناقص حتى قرر جسده التقاعد من الحياة، وقررت روحه التخلص من العذاب، وقرر عقله التنازل عن ملكاته ومملكته، وقرر قلبه التوقف عن النبض... وفي لحظات غاب عنا، كأنه لم يكن موجوداً بيننا في أي يوم من الأيام. لكن ما حدث لخالي في ذلك اليوم العصيب من صيف عام 1959، لم يتركني أعيش أحزاني بصمت، بل عاقبني عقاباً شديداً... عقاباً سنأتي على ذكره حين نصل إلى تلك النقطة ونتوقف عند ذلك المكان والزمان.

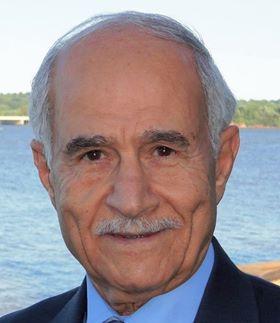
إضافة تعليق جديد