الشتات - الحلقة الثالثة "الأسرة والحياة العائلية "

كان البيت الذي ولدتُ فيه كبيراً وفخماً وجميلاً جداً، ربما كان أكبر وأجمل بيوت يازور في حينه... كان بيتاً حضريا بكل معنى الكلمة، له أعمدة في الخارج وأعمدة في الداخل، وبهو واسع يقودك إلى عدة غرف وصالات جلوس. وكما أخبرني عمي، اشترى الوالد بلاط البيت من أفضل مصنع في فلسطين تخصص في صناعة البلاط الفخم، مصنع السيسة في مدينة القدس. ولقد شهد ذلك البيت الذي أقيم في الطرف الغربي من بلدة يازور، على حدود مستعمرة نيتر اليهودية أحداثاً عائلية مهمة، منها زواج عمي من ابنة عمه التي وهبها والدها له يوم ميلادها ومات قبل أن يحضر زفافها. كما شهد أيضاً انتقال ثلاث عائلات يهودية للعيش معنا جزءاً من سنوات الحرب العالمية الثانية بعد أن قام الطيران الايطالي بالإغارة على مدينة تل أبيب، أكبر المدن اليهودية في فلسطين. وفي ذلك البيت الشاعري، وفي ظلال أشجار البرتقال وأريج الليمون وقع عمي في حب فتاة من بنات العائلات اليهودية التي استضفناها في بيتنا ووفرنا لها مكاناً آمناً تقيم فيه بعيداً عن أجواء الحرب ومخاطرها اليومية. نعم... لقد وفرنا لضيوفنا الأمان حين التجأوا إلينا هرباً من فاشية ايطاليا ونازية ألمانيا دون أن نعلم أن أقاربهم وذويهم وأحفادهم سيقومون بعد سنوات قليلة باستعارة فاشية ايطاليا ونازية ألمانيا واستخدام أساليب القتل والدمار والإرهاب والتعذيب ضدنا. لم يكن بإمكاننا أن نعلم أو حتى أن نتخيل أنهم سيقومون بعمليات تطهير عرقي ضدنا تمحي وجودنا من البيت وآثارنا من القرية، وتصادر طفولة أطفالنا، وتَسْلب الأمان والطمأنينة من قلوبنا وعيوننا إلى الأبد.
كانت عائلة "باخور" هي إحدى العائلات اليهودية التي لجأت إلينا، وكان السيد باخور رجل أعمال معروف في تل أبيب يعمل في المقاولات وأعمال البناء والعقارات، وله ابنتان وابن واحد، "هداسا وأليسا وأبراهام". ويبدو أن الشعور بالإعجاب بين عمي، واسمه "جمعة"، وأليسا كان متبادلاً، إذ نما بسرعة وتحول إلى علاقة حب وحدت بين قلبي العشيقين. إلا أن الحب لم يعمر طويلاً لأن العائلة عارضته بشدة، ولأن ابنة عمه "رحمة" كانت تنتظره بفارغ الصبر وقد تفتحت كل براعم الأنوثة في قلبها وعلى صدرها، ولأن الخطر الذي لاح في الأفق بالنسبة ليهود فلسطين زال بسرعة بعد انحسار القوة العسكرية النازية، ما شجع ضيوفنا الهاربين على العودة إلى بيوتهم ومدينتهم سالمين. لكن الحب، حتى وإن ضاع الحبيب، وخانته ظروف الحياة، وذوى العشق في قلبه، وشاخ الزمن الذي ولد فيه، لا يموت أبداً... إن لمسات الحب وعواطفه وقبلاته تبقى زكية تعطر الذاكرة وتبهج الأيام القاتمة، تأتي على شكل هذيان يسرق الحبيب من هموم يومه، يُسعد قلبه، ويحمل البسمة إلى وجهه. إذ على الرغم من مرور ما يقارب 65 سنة على حادثة الحب بين عمي وأليسا، وفقدان عمي لكل شيء مادي جمعه في حياته قبل مغادرة يازور، إلا أن صورة حبيبته رافقته رحلة عمره الطويل حتى شهر يناير كانون الثاني 2008، حين قرر، بينما كنت أراجع معه بعض المعلومات استعداداً لكتابة هذه المذكرات، أن يعطيني تلك الصورة... صورة لصبية هادئة رائعة الجمال. وبعد أن سلمني الصورة سألني قائلا، هل تعتقد يا محمد أنها ما تزال حية حتى اليوم؟ وأين هي؟ هل ما تزال تعيش في فلسطين أم هاجرت إلى أمريكا كما كانت تقول لي؟ وهنا لمحت حزناً عميقاً في عينيه التي كاد دمعها المعتق بسنوات الشوق والعذاب والتهجير يبكي ويتنازل عن كبريائه... سكت عمي قليلاً ثم قال مُتسائلا، تُرى ما شعورها تجاهنا اليوم وهي تعلم ما فعل شعبها بنا؟ وكيف تنظر إلى قيام اليهود باغتصاب حقوقنا والتنكر لحقنا في العودة إلى ديارنا ووطننا؟ هل يا تُرى عادت لزيارة ذلك البيت الوديع الذي عاشت فيه قصة حب جميلة؟ هل قامت عائلتها باحتلال البيت باعتباره مهد ذكريات لهم ومكاناً آمناً وعزيزاً عليهم؟ أتمنى أن يكونوا قد فعلوا ذلك، لأن من المؤكد أن يدفعهم حبهم للبيت وتجربتهم الآمنة الجميلة فيه إلى الحفاظ عليه، ولأن دموع أليسا سوف ترطب الذكريات التي تسكنه كي تبقى روح الحب حية فيه ومن حوله، ويبقى البيت شعاراً لحق يأبى الموت، وذكريات تأبى النسيان.
ولد والدي عبد العزيز، الذي كان أهل القرية يسمونه "العبد أبو ربيع"، في يازور في أوائل القرن العشرين، وعاش حتى سنة 1995 حين وافته المنية في جبل النزهة في مدينة عمان، وبذلك يكون قد عاش حوالي 90 عاما. عمل الوالد في صباه في "مشاغل" البرتقال، وذلك كغيره من الفتيان الذين لم تسمح لهم ظروف الحكم التركي وأحداث الحرب العالمية الأولى بالالتحاق بالمدارس. "مشغل" البرتقال هو شركة صغيرة أو كبيرة نوعاً ما تقوم عادة بِ "ضمان" بساتين البرتقال من مالكيها، أي شراء محصول البرتقال قبل نضوج الثمار بأشهر، والقيام في موعد الحصاد بإرسال عمالها لقطف الثمار وإعدادها للتصدير. أما عملية قطف المحاصيل وإعداد الثمار للتصدير فكانت تتم على مراحل: قطف الثمار عن الأشجار أولاً، ثم نقلها إلى مكان مركزي على أطراف البستان أو البيارة، تتبعه عملية فرز البرتقال الصالح للتصدير من غيره، ثم لف حبات البرتقال الصالحة للتصدير بورق ناعم استعداداً لتعبئتها في صناديق خشبية خاصة كان نجارون متخصصون يقومون بتجهيزها على أرض الموقع، وأخيراً القيام بشحن صناديق البرتقال إلى الموانئ استعداداً لتصديرها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. كانت أعمال قطف الثمار ونقلها من اختصاص الوافدين من العمال الذين كانوا يأتون عادة من مصر ومنطقة حوران في سورية، وكانت العمليات الأخرى من اختصاص شباب فلسطين. كان موسم البرتقال الذي يستغرق بضعة أسابيع، يجتذب ما لا يقل عن خمسين ألف عامل سوري ومصري للعمل في مشاغل البرتقال كل عام، تعود الغالبية العظمى منهم إلى بلادهم بعد انتهاء الموسم، فيما يتخلف البعض الآخر لمواصلة العمل في مزارع وموانئ فلسطين، والعيش بصفة دائمة أو شبه دائمة في إحدى المدن أو القرى الفلسطينية، ويغدو مع الأيام جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني.
خالتي "صفية" هي الأخت الوحيدة لأمي "صبحه"، وخالي "عبد العزيز" هو الأخ الوحيد لأمي وخالتي، أما جدتي من ناحية والدتي فاسمها "فاطمة". وبينما ماتت خالتي في شهر يوليو تموز عام 2009 بعد أن عاشت عمراً طويلاً، مات خالي شاباً في مخيم عقبة جبر في ظروف مأساوية تعود لتبعات نكبة الشعب الفلسطيني في عام 1948. مات خالي عبد العزيز بيرم دون أن يفارقه الأمل بالعودة إلى فلسطين والاقتران بخطيبته التي كانت تنتمي لعائلة "حجاب" من يافا، تلك الخطيبة التي عشقها وقدم لها كل ما كان باستطاعته كي تقبل به، أو بالأحرى كي تتنازل عائلة يافاوية "مدنية" وتقبل بخطوبة ابنتها لشاب ينتمي لعائلة "قروية"، على الرغم من أن خالي عاش معظم حياته في يافا، يدرس في مدارسها ويتسكع في شوارعها ومقاهيها. أما جدتي الحاجة فاطمة، تلك المرأة الوديعة المسالمة فقد عاشت حياتها منذ النكبة بين بيتنا وبيت خالتي في مخيم عقبة جبر، ومن ثم في أريحا وبعدها في عمان، وذلك حتى وفاتها في عام 1972 في مدينة عمان. وفي أريحا، قامت جدتي فاطمة، والتي كنا نسميها "ستي"، باسم الدين وتمسكا بقشوره بارتكاب خطأ كبير لا يقبل به عقل مستنير، ولا يجيزه منطق في مجتمع متحضر يعي معنى التاريخ ويقدر قيمة التراث الإنساني... قصة مؤسفة سنأتي على ذكرها حين نصل إلى الزمن الذي وقعت فيه.
كان بيت جدتي فاطمة وجدي عبد اللطيف بيرم الذي مات قبل أن أرى النور من أجمل بيوت يازور، يقع على تلة عالية مشرفة، له شرفات واسعة تطل على بساتين البرتقال في يازور، وعلى مدينة يافا وبحرها، وعلى المستوطنات اليهودية المجاورة. أما جدي من ناحية أبي واسمه "محمد" فقد كان له أخ واحد فقط اسمه إسماعيل. وبالرغم من أن كل جدة من الجدات عاشت طويلا، إلا أن الأجداد، بمن فيهم إسماعيل، ماتوا جميعا في سن الشباب، ما تسبب في ترك زوجاتهم وأولادهم وبناتهم بحاجة لولي أمر يعتني بهم ويحميهم ويحافظ على ممتلكاتهم، وهذا ما نذر العبد أبو ربيع نفسه للقيام به، ما جعله يُهمل زوجته وأولاده أحياناً. كان العبد أبو ربيع رجلاً شهماً وكريماً وشجاعاً في آن واحد، وأميناً بكل ما للكلمة من معنى، ولذا كان قدوة للأصدقاء والأقارب، وملجأ آمناً يلتجئ إليه كل من كان لديه شيئاً ثميناً يخاف عليه، أو سراً لا يستطيع البوح به ويبحث عن شخص يأتمنه عليه. ولقد استمر العبد أبو ربيع يقوم بهذا الدور حتى بعد الهجرة والتشرد، على الرغم من تزايد مشاغله واضطراره لإعطاء المزيد من الاهتمام لتربية أطفاله وتوفير احتياجاتهم الحياتية.
قام العبد أبو ربيع في عام 1944 ببيع ذلك البيت الجميل الذي ولدت فيه والبيارة المحيطة به وشراء بيارة أكبر في مكان بعيد نسبياً يقع في جنوب شرق القرية، حيث أقام عليه بيتاً ريفياً متواضعاً لكن مريحاً. لكن جدتي من ناحية الوالد التي كانوا يسمونها "حِسِنْ" مع أن اسمها الحقيقي هو "حُسُنْ"، رفضت فكرة الرحيل بعيداً عن مهد الذكريات، ما دفع والدي للاحتفاظ بقطعة أرض مجاورة لذلك البيت، أعتقد أن مساحتها كانت في حدود عشرين دونماً، أي 20 ألف متر مربع. أقام الوالد على تلك القطعة بيتاً صغيراً لوالدته وقام بتسجيل الأرض والبيت باسمها، وهي خطوة كان لها تبعات إيجابية أنقذتنا بعد سنوات من فقر وجوع محقق. كان لبيت العائلة الجديد ساحة أمامية كبيرة، أو حوش في وسطه شجرة توت عملاقة تُخفي تحتها بندقية والدي التي لم تكن تفارقه أبداً. كان العبد أبو ربيع يُخرج بندقيته الملفوفة بعناية بالقماش المشمع بين الحين والآخر، يأخذها إلى داخل البيارة كلما أراد تفقدها، وهناك كان ينظفها ويزيتها ويتغزل بها، بينما كنت أقف حارساً بين الأشجار حتى يُكمل مهمته... كنت أقف بالقرب من باب البيت أراقب الشارع الضيق الذي يصل بيتنا وبيت عائلة المبروك بالشارع الرئيسي المسمى "شارع السَلاقة". ويبدو أن أهل القرية أطلقوا ذلك الاسم على الشارع لأن رماله البيضاء الناعمة كانت "تسلق" أقدام من يسير عليها حافياً في أشهر الصيف الحارة كما تسلق نار الشواء البيض. وفي الزاوية الضيقة التي تقع خلف باب غرفة نومه تماماً، حفر العبد أبو ربيع حفرة صغيرة كان عمقها حوالي ستين سنتيمتراً، وقطرها حوالي الأربعين، شيد جدرانها الداخلية بالاسمنت، وترك البلاطة التي تغطيها بدون اسمنت، ما جعلها تغدو بمثابة غطاء متحرك تسهل إزالته عند الحاجة والوصول إلى ما كان في داخل الحفرة من أشياء. وهذا جعل الحفرة في واقع الأمر خزنة سرية آمنة، احتفظ والدي في داخلها بمسدسه ومجوهرات أمي والسندات الرسمية والأوراق الثبوتية المتعلقة بملكية الأرض والبيت وشهادات الميلاد وغير ذلك من وثائق ونقود. كانت الخزنة تختفي تماماً حين يُفتح باب الغرفة، وبالتالي لم يستطيع جنود الاستعمار البريطاني الذين فتشوا البيت مراراً وتكراراً العثور عليها ولا على ما كانت تخفي في داخلها من سلاح خطير استحق مالكه في حينه الإعدام.
كان لجدتي حِسِنْ ووالدي وعمي العديد من الأصدقاء اليهود الذين جاء معظمهم من اليمن، من بينهم "سعدية" وعائلتها الصغيرة وزوجها الحاخام الذي كان لون بشرته يقترب من سواد الأفارقة. كانت سعدية تتكلم العربية بطلاقة، وتتصرف كامرأة عربية من حيث العادات والتقاليد لكونها عربية وإن ورثت اليهودية عن أجدادها. وكما تشير كتب التاريخ القديمة، وكما اكتشف بعض مؤرخي الدولة العبرية حديثاً، تعود أصول الجالية اليهودية اليمنية إلى مملكة حِمْيَر التي اعتنقت اليهودية في القرن الرابع الميلادي، وتخلى معظم سكانها عن ديانتهم حين اتخذوا الإسلام ديناً بديلا في القرن السابع الميلادي.
كانت عائلة أبو ربيع وعائلة سعدية يتبادلون الزيارات والهدايا بشكل متواصل، خاصة في المناسبات والأعياد، وحين يتعرض أحد أفراد العائلتين إلى وعكة صحية. وفي بيت سعدية في مستوطنة "أجروبنك" تذوقت طعم الزبدة لأول مرة... كان الطعم شهياً ولذيذاً دفعني إلى التعود عليه وتناولة بشكل مستمر في كل صباح تقريبا مع مربى البرتقال، وذلك حتى اكتشف العلم مادة الكولسترول، وتعرف على ما لها من مضار ومخاطر على القلب، ما أفسد ذلك الطعم اللذيذ ودفعني في السبعينيات إلى الابتعاد عن تناول الزبدة كليا.
تعرفتْ جدتي حِسِنْ من خلال صديقتها سعدية على تجار يهود كانوا يتاجرون باللحوم ويقومون بذبح الأبقار في أيام السبت خلافاً للتعاليم الدينية اليهودية، وذلك بالتواطؤ مع زوجها الحاخام. وحيث أنه كان من شبه المستحيل إتمام عمليات الذبح في مستوطنات يهودية، فإن أولئك التجار اتفقوا مع جدتي على القيام بعمليات الذبح والسلخ في مزرعتها المتواضعة، وذلك مقابل مبالغ جيدة من المال. كما كان الاتفاق مع التجار اليهود ينص على ترك بعض أجزاء الذبيحة، خاصة الرأس والأرجل والمعدة وغيرها من أمعاء داخلية لجدتي لتتصرف بها كما تشاء. وهذه لحوم ودهون كانت مرغوبة من أهالي القرى الفلسطينية عامة، ما جعل جدتي تقوم ببيع بعض تلك الأشياء وإهداء البعض الآخر للجيران والأقرباء والأصدقاء، وتكديس ما تحصل عليه من دخل في وسادات ومخدات... كان عمي جمعة هو المستفيد الأول والأكبر من تلك الأموال. وعلى الرغم من أن جدتي كانت كريمة مع كل المقربين منها وسخية في إعطاء الصدقات للغرباء، إلا أن والدي لم يسألها في أي يوم من الأيام عما كان لديها من مال ولا كيف كانت تنفقه. وحين وصلنا إلى مخيم عقبة جبر أوائل عام 1949، كان كل ما تبقى في جيب والدي بعد عام كامل من التنقل في محطات الشتات داخل فلسطين هو ثلاثة قروش ونصف القرش فقط، ليُعيل بها عائلة مكونة من تسعة أشخاص. وهنا جاء دور جدتي وما كانت قد ادخرته من مال لإنقاذنا مؤقتا من شبح الجوع والحاجة، ولمساعدتنا على تخطي أزمة مصيرية.
يقع بيت جدتي حِسِنْ المكون من غرفة واحدة ومطبخ صغير وساحة أمامية وبيت للدجاج في طرف القرية الغربي بالقرب من مستعمرة "نيتر" الزراعية، حيث لم يفصل أرضنا عن تلك المستعمرة سوى شارع رئيسي عريض نسبياً يربط تلك المنطقة بالطريق الدولي. كانت جدتي، والتي كنت أناديها "ستي" تحبني كثيراً وكنت أقضي في أحضانها ليلتين أو أكثر من كل أسبوع، كما كان والدي يزورها كل يوم تقريبا. أما مستعمرة نيتر المجاورة فكانت مزروعة بعديد من أنواع الفواكه، أهمها أشجار اللوز القريبة منا، وكان زهر اللوز وثماره مغرية جداً، ما حدا بي في سنة 1947، ومعي أختي الكبرى يسرى وأخي محمود الذي يصغرني بعام ونصف تقريباً أن نستغفل الأهل ونتسلل إلى المستعمرة من تحت السور المصنوع من الأسلاك الشائكة، وهناك قمنا بقطف بعض ثمار اللوز الطرية. ولسوء حظنا في ذلك اليوم، رآنا حارس المستعمرة اليهودي واسمه "دودو"، ما جعله يركض بحصانه نحونا ويطلق صفارته بصوتها القوي المرعب. وهذا جعلنا نرتعد من الخوف ونتجمد في مكاننا ونبدأ في البكاء والصراخ. إلا أن والدي لم يكن يبعد عنا سوى عشرات الخطوات، ولذا جاء مُسرعاً وبيده بندقيته حين سمع صفارة دودو وصراخنا. صرخ الوالد في وجه دودو بغضب وصوب فوهة البندقيه نحوه مهدداً باطلاق النار. تراجع دودو بسرعة... أدار وجه حصانه وفر هارباً داخل المستعمرة. قطع والدي بعض الأسلاك وأخرجنا من المستوطنة، وعاقبنا بعد أن زال الرعب من قلوبنا بما كنا نستحق من عقاب.
لكن غضب العبد أبو ربيع لم يهدأ حتى انتقم بطريقته الخاصة من تلك المستعمرة ومن حارسها ومن مستوطنيها. ففي زيارة تالية لبيت جدتي، لاحظنا وجود ثور كبير بالقرب من سور المستوطنة، يبدو أنه هرب من حظيرته، ما دفع والدي إلى حمل بندقيته على كتفه، والتوجه نحو الثور، وفيما وقف الوالد لدودو بالمرصاد، قام ثلاثة شباب من أبناء الجيران المتواجدين يومها في الموقع بقطع الأسلاك الشائكة بمقص كبير، بينما كان دودو يراقب ما يجري عن بعد دون أن يجرؤ على إطلاق صفارته كالمعتاد خوفا من العواقب، ثم قاموا بجر الثور بصعوبة وإخراجه من المستوطنة، حيث تم ذبحه وتوزيع لحمه على الأقارب والجيران. كان والدي يحمل بندقيته علناً أحياناً، ويمر في شوارع البلدة أمام عيون الناس وهي معلقة على كتفه، فيما كان البريطانيون يحكمون على كل من يجدون لديه بقايا طلقة فارغة بالإعدام شنقاً... كان العبد أبو ربيع شاباً شجاعا وكريماً، معتزاً بنفسه ومخلصاً لأصدقائه، وإن اقترب كرمه أحياناً من التبذير واقتربت شجاعته أحياناً من التهور.
كنا نشترك في بئرين ارتوازيين مع جيراننا وأقاربنا من عائلتي المبروك وأبو ناموس، وكان لكل بئر منها بركة ماء كبيرة نسبياً تُستخدم مياهها للسباحة وري الخضروات والمشاتل التي تحتاج لري أكثر من مرة في الأسبوع. أما المضخات فقد كانت ألمانية الصنع، تُشغل مرة كل أسبوع لضخ الماء من الآبار لري المزروعات وتغيير مياه البرك، وكان العبد أبو ربيع يعتز بمهاراته في تشغيل المضخات والعناية بها وإصلاحها عند الحاجة. وحيث أن مياه الري كانت تمر عبر قنوات رملية إلى الأشجار البعيدة وأحواض الخضراوات، فإن تلك القنوات أصبحت مرتعا للضفادع التي كانت تُزعجنا نهاراً وتقض مضاجعنا ليلاً، ما جعلني أتضايق منها وأمقت ملمسها اللزج. وحتى بعد أن سافرت إلى أوروبا في الستينيات واكتشفت أنها من المأكولات الشهية، بل من المقبلات التي لا يأكلها سوى الميسورين من الناس، لم أغير نظرتي إليها، ولذا لم أتذوق طعمها في حياتي. كان عمي "جمعة" كثيراً ما يعود إلى البيت متأخراً في الليل، وبعد قيامه بخلع ملابسه كان يذهب غالباً إلى البركة ليستحم في مياهها، أحياناً في وسط الليل. كنت كلما سمعت صوت الماء أعرف أنه هناك فأنهض من فراشي وأفاجئه بأن اغطس تحت الماء بهدوء وأمسكه من قدمه على حين غرة. وعلى الرغم من تكرار تلك الحادثة مرات ومرات، إلا أن عمي كان يقفز مرتعداً من الخوف كلما مسكته من قدمه. كان يحبني ويدللني، وكنت أحبه كثيراً وأحب البقاء معه وبالقرب منه، أتعلم منه أشياء كثيرة لم يكن والدي الذي يكبره بحوالي 20 عاما يرضى عن بعضها.
قضى عمي جمعة معظم حياته وشبابه في مدينة يافا، ما أعطاه فرصاً كثيرة لتكوين صداقات جيدة مع شبابها، كان من بينهم صديق يهوى السيارات والدراجات، اسمه لطفي النابلسي... كان لطفي على ما بدا لي ثرياً أو ميسور الحال. وفي مرة من المرات، جاء لطفي لزيارتنا، وترك سيارته أمام الباب الرئيسي، ودخل مع عمي وصديقين آخرين داخل البيارة ومعهم زجاجات اعتقد أنها كانت من النبيذ أو الويسكي. ومن أجل التخلص مني، قام أحدهم بنفخ دخان سيجارته في وجهي، ما جعلني أشعر وكأن بؤبؤ عيني يحترق في نار. نهضت مسرعاً، شتمتهم جميعاً من دون تردد، وسرت بهدوء نحو البيت. إلا أنني حين وصلت هناك، لاحظت أن السيارة كانت واقفة أمام الباب... أغراني منظرها، حيث رأيت فيها لعبة أتسلى بها، ولذا حاولت أن أقلد عمي وأقوم بتشغيلها، إلا أنني كلما ضغطت على زر التشغيل وسمعت صوت المحرك ورأيت السيارة تتحرك قليلاً كنت أخاف وأتوقف، ثم أعود ثانية وأكرر ما فعلت. وحين عاد الأصدقاء بعد أن قضوا وقتاً جميلاً وانتهت الحفلة، كانت مفاجأتهم كبيرة، إذ اكتشفوا أن السيارة معطلة... كنت قد لعبت بها وقتاً كافياً لإفراغ البطارية من شحنتها، وهنا هربت من وجههم في داخل البيارة ولدي شعور بالتشفي.
هناك تجربتان سلبيتان حدثتا أمامي وكان لهما أثر ايجابي كبير على حياتي: الأولى نفخ دخان السيجارة في عيني، حيث جعلني ذلك الحدث أكره السيجارة والتدخين كرهاً شديداً، وقادني إلى اتخاذ موقف معادٍ للتدخين بشكل عام... وهو موقف ترسخ بعد أن تعرف العلم على المضار الصحية الكثيرة والخطيرة للسيجارة. ولذا لم أدخن سيجارة واحدة في حياتي، ورفضت كل توسلات الوالد أن أشتري له بعض علب السجاير من الطائرة حين كنت اذهب لزيارتهم في عمان أثناء عملي في جامعة الكويت. كان والدي قد تعلم التدخين بعد نكبة عام 1948، ولم يقلع عنه إلا في عام 1978، أي بعد مرور ثلاثين سنة. أما الشيء السيىء الثاني الذي كان له أثر ايجابي على حياتي فقد حدث في أريحا بعد سنوات حين رأيت رجلاً وقد فقد وعيه من كثرة ما شرب من الخمر في أحد الأعياد، وبدأ يترنح بشكل مضحك ما دفع العديد من الصبية والشباب إلى التجمع حوله والاستهزاء به. وحيث أنه لم يكن باستطاعة ذلك الرجل الوقوف على قدميه من كثرة السكر، فإن رجال الأمن وضعوه في عربة من العربات الحديدية التي كانت تُستخدم لجمع القمامة والزبالة من الشوارع ونقلها إلى المحرقة. إلا أن الرجل الذي كان في حينه في عداد المعتوهين، ظن نفسه ملكاً أو رئيس دولة يركب سيارة فخمة مكشوفة، وأن الجماهير التي تجمعت من حوله تستهزئ به جاءت كي تحييه وتهتف بحياته، ما جعله يلوح بيده محيياً الجماهير على جانبي الطريق. وهذا أقنعني بالابتعاد عن الخمر والحذر من مغبة أن أقع في نفس المأزق، ولذا لم انجرف مع أصدقائي من الشباب فيما بعد خلف السيجارة أو شرب الكحول، أو حتى الإدمان على شيء له علاقة بالأكل أو الشرب أو اللهو... نعم لقد أدمنت على هوايات عديدة منها حب الناس والقراءة والكتابة والطبيعة والسفر والتدريس الجامعي.
علمني والدي كيف أضع أصابعي في فمي وأصفر نغمات متعددة، استخدمناها وسيلة اتصال فيما بيننا. الصفرة الواحدة كانت تعني "أنا هنا"، اما الصفرتان فكانت تعني "تعال"، وتكرارها ثلاثاً كان يعني "لا تأتي، سآتي أنا". لذا كنت بعد أن أصحو من النوم في الصباح، وبعد أن أعود من المدرسة في الظهيرة، أطلق صفارتي عالية فيرد علي والدي، وبالتالي أعرف مكان وجوده في البيارة. أذهب إليه مسرعاً فيخبرني عن الأشياء التي كنت أحبها وأتابعها بشغف: بيوت العصافير التي بدأت في تكوينها، عدد البيض في البيوت التي تمت عملية بنائها حديثاً، وما نوع تلك العصافير؟ وما حجم العصافير التي كانت بيضاً وفقست قبل أيام؟ وهل طارت؟ أي هل نمت بما يكفي وهجرت بيوتها وسافرت مع غيرها من العصافير عبر المسافات؟ كانت العصافير وسيرة حياتها وأنواعها وألوانها وأنغامها ومواسم قدومها وهجرتها أكثر الأشياء التي جذبتني في طفولتي، حتى توقفت تلك الطفولة عن النمو في الشهر الأول من عام 1948، وحُرِمتْ من تذوق طعم الفرح والتمتع بسماع دعاء العصافير تستقبل الصباح، وتودع النهار في المساء. كان الهُدهُد هو أكثر الطيور التي سحرتني بريشها وألوانها الخلابة وكبريائها، ولذا عز علي فراقها كثيراً. وعلى الرغم من عشقي للعصافير والطيور، إلا أن علاقتي معها لم تكن علاقة حب وعشق فقط، بل كانت أيضاً علاقة تنافس. كنا نتنافس على ثمار الجوافة والتين بشكل خاص، ولم يزعجني أبداً أن آكل حبة تين أو جوافة سبقتني العصافير إلى تذوق طعمها، لأن لدى العصافير حساً غريزياً غريباً يدلها على أفضل حبات التين والجوافة الناضجة.
توفي جدي لأبي وكذلك جدي لأمي قبل ميلادي وميلاد أختي الكبرى بأعوام، لذلك فقد أبي والده في سن الشباب، ما جعله يحن لذلك ويعامل كل رجل أكبر منه سناً كوالده. وبسبب حاجة العبد أبو ربيع لمساعدة مستمرة للعناية بالبيارة، وفي ضوء انشغال عمي بنشاطات شبابية لا تمت للزراعة بصلة، كالتمثيل والرياضة والسيارات، وجد والدي نفسه بحاجة ماسة لمن يساعده بشكل دائم. ولقد وجد ضالته في رجل مخلص طيب القلب كان يكبره بسنوات من قرية وادي حنين، القرية التي تقع إلى الجنوب من قرية بيت دجن. كان والدي ينادي ذلك الرجل الذي عاش معنا وفي بيتنا "يابا" أي يا والدي، ويحن عليه ويعامله بلطف واحترام، حتى حين يخطئ. وفي يوم من الأيام، أخذني ذلك الرجل معه إلى قريته على ظهر حمار لأحضر حفلة زفاف أحد أبنائه الثمانية. إلا أنني هربت في صباح اليوم التالي من القرية وسرت مُسرعاً في اتجاه يازور، حيث اتبعت نفس الطريق التي سلكناها من يازور عبر بيت دجن إلى وادي حنين، لكن أحد أولاده ركب حصانه وتبعني. وفيما كنت جالساً على دوار بيت دجن أراقب المارة وآخذ قسطاً من الراحة، فجأني ذلك الشاب، وحملني على حصانه، وعدنا إلى وادي حنين. كانت هناك نكتة تقول: "إذا توشوش أهل يازور، أهل بيت دجن بسمعوهم"، أي أن سكان بيت دجن يسمعون همس سكان يازور، وذلك لشدة قرب يازور من بيت دجن. إلا أن المسافات القريبة بين القريتين، وعلاقات النسب والجوار والصداقة التي ربطت أبناء البلدتين بروابط قوية، لم تكن كافية لتوحيد لهجاتهم أو عاداتهم وتقاليدهم. كان أهل بيت دجن أكثر تحرراً من النواحي الاجتماعية من أهل يازور، وكانت لهجتهم أكثر ليونة، يمطون الكلمات كأنهم يمضغونها. أما أهل يازور فكانوا أكثر صلابة وتسامحاً مع الغير، ما جعل يازور تستضيف الكثير من الغرباء الذين جاؤوا للسكنى والعمل والتجارة في مدينة يافا. ومن بين الغرباء الذين سكنوا يازور جماعة كانت تُدعى الُغْربية" جاءوا إلى فلسطين من تونس والمغرب ومصر، وسكنوا على أطراف يازور، امتهنوا بشكل أساسي حرفة الحدادة، خاصة صناعة أدوات الزراعة والسكاكين والمناشير وما شابه ذلك.
لم يكن ذلك الشيخ الطيب الذي كنت أناديه "سيدي" أي جدي، هو الشخص الوحيد الذي انضم إلى عائلتنا الصغيرة في يازور وأصبح واحداً منا. كان هناك أيضاً شخص آخر اسمه فارس، جاء صبياً من قرية "بيت دَراس" التي تقع في جنوب فلسطين على بعد 30 كيلومتراً تقريباً من مدينة غزة، وعاش معنا طويلاً وعمل في بيارتنا حتى أصبح واحداً من أبناء العائلة، وهذا جعله يكتسب اسم "فارس أبو ربيع"، لكن اسمه الحقيقي هو فارس محمود خليل شاهين. وبسبب كونه واحداً من أبناء العائلة، ولم يكن يُعامل كعامل زراعي لديها، فإن والدي زوجه ابنة خالته التي كانت من أهالي قلقيلية. وكما علمت ما تزال ابنة الخال تعيش مع أولادها وأحفادها اليوم في عمان كغيرهم من أبناء يازور. وحين فتحت عيني على الدنيا، وجدت امرأة سمراء جميلة القوام حولي، أحببتها كثيراً وأحبتني أكثر، كنت أناديها وحتى وفاتها في عمان بعد أكثر من 60 عاماً، عمتي "حليمة". أما أهل البلدة فقد كانوا يسمونها "حليمة البدوية".
جاءت الصبية حليمة إلى يازور بعد رحلة طويلة وشاقة لا ندري كم استغرقت من الوقت، قطعت خلالها نهر الأردن وعدة مدن وعشرات القرى الفلسطينية وحوالي 80 كيلومتراً مشياً على الأقدام. كانت حليمة التي تنتمي لعشيرة العدوان التي تسكن في منطقة الأغوار الأردنية على الجانب الشرقي لنهر الأردن، قد هربت من وطنها وبيت عائلتها ومضارب عشيرتها بعد أن تعرضت لظروف غير عادية. قطعت حليمة النهر وعبرت إلى الضفة الغربية، أي إلى فلسطين، ووصلت يازور بعد رحلة طويلة لا نعرف عن تفاصيلها شيئاً. لكنها حين وصلت يازور، وكانت في حينها حاملاً، كان من حسن حظها أنها وجدت جدتي "حِسِنْ" هناك لاستقبالها. أخذتها جدتي إلى البيت وتبنتها، وضمتها إلى عائلتها الصغيرة، وعاملتها كابنة لها وذلك حتى وفاة الحاجة في عام 1976 في السعودية. كانت جدتي على ما يبدو تشعر بحاجة نفسية لابنة بعد أن حرمها القدر من أن تكون أماً لبنت من لحمها ودمها. لقد أنجبت جدتي أكثر من عشرة أولاد وبنات، لم يعش منهم سوى إثنين، والدي عبد العزيز وعمي جمعة. وإذا كان "فارس أبو ربيع" قد حصل على كنيته نتيجة لقيام والدي بضمه لعائلتنا، فإن "حليمة البدوية" حصلت على اسم عائلتنا في السجلات الرسمية بعد أن تبنتها ستي وآخاها والدي وعمي. تزوجت العمة حليمة أكثر من مرة، لكنها لم تنجب ولداً أو بنتاً، حتى الجنين الذي حملته معها من الأردن، والذي كان على ما يبدو سبب لجوئها إلى فلسطين، مات قبل أن يرى النور. لقد تم الزواج الأول بمساعدة والدي من رجل أعمال كان يعمل في التجارة، قدم إلى يافا من قرية دورة القريبة من مدينة الخليل، وكان يسكن في "سكنة أبو كبير" في يافا. وفي بيت عمتي حليمة وزوجها أبو العبد قضيت ليالي كثيرة وأياماً جميلة، صاحبت عمتي فيها إلى سوق يافا وبحرها وشواطئها الساحرة.
حين بلغتُ الرابعة من العمر تقريبا أخذني والدي إلى مقام الإمام علي وسلمني هناك لشيخ الجامع الذي تعلمت على يديه حروف الكتابة والأرقام وبعض الآيات القرآنية، وحين بلغت سن الدراسة التحقت بمدرسة يازور الابتدائية. كنت أمر في ذهابي إلى المدرسة ومنها عائداً إلى البيت عبر بيارتنا أولاً، ثم عبر بيارة عائلة أبو ناموس، وبعدها أقطع مقبرة القرية التي تحوي مقام أحد الأولياء المسمى "سيدنا القطناني"، ثم أعبر الطريق الرئيسي الذي يربط يافا بالقدس وصولاً إلى المدرسة. وفي مدرسة يازور عوقبت جسدياً لأول وآخر مرة في حياتي بسبب عملية غش في امتحان لم أرتكبها. كان أحد زملائي في الصف الثالث الابتدائي من عائلة حرز الله، وكان عمه هو مدرس مادة الحساب. وخلال تصحيح أوراق أحد الامتحانات اكتشف الأستاذ أن ابن أخيه كتب الجواب الصحيح لمسألة رياضية دون أن يتوصل إليه من خلال عملية حسابية صحيحة، ما يعني أنه نقل الجواب عن تلميذ آخر. وتحت الضغط والتهديد، اعترف التلميذ بأنه نقل الجواب مني دون علمي، وأنه تمكن من ذلك لأنه كان يجلس خلفي تماماً. عاقبني الأستاذ أحمد حرز الله بغيظ شديد لأنني رفضت الاعتراف بذنب لم ارتكبه، ورفضت خلع حذائي كي يضربني "فلقة" كما فعل مع ابن أخيه أمام جميع التلاميذ، ما جعله يجبرني على فتح يدي ويضربني بقسوة بعصاه الغليظة، وذلك بعد أن كدت ألوذ بالفرار من قاعة الدرس. غضب والدي كثيراً حين علم بما حدث، وكاد يذهب لينتقم من الأستاذ لولا تدخل أعمامي الذين أقنعوه بأن ذلك قد يتسبب في وقوع خصام بين عائلتين في البلدة، فيما أقنعوا الأستاذ بالاعتذار للوالد بسرعة. إلا أنني لم أدخل صف الأستاذ أحمد حرز الله بعد تلك الحادثة لأكثر من سبب، أهمها أن المناوشات بين أهالي البلدة والعصابات الإرهابية اليهودية كانت قد بدأت، ما أدى إلى إقفال المدرسة وتسبب في تعطل الدراسة.

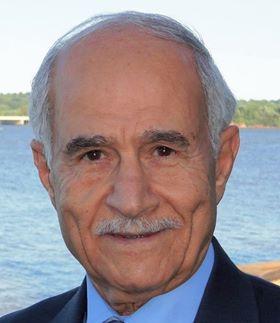
إضافة تعليق جديد