الشتات - الحلقة الرابعة " من التراث الشعبي
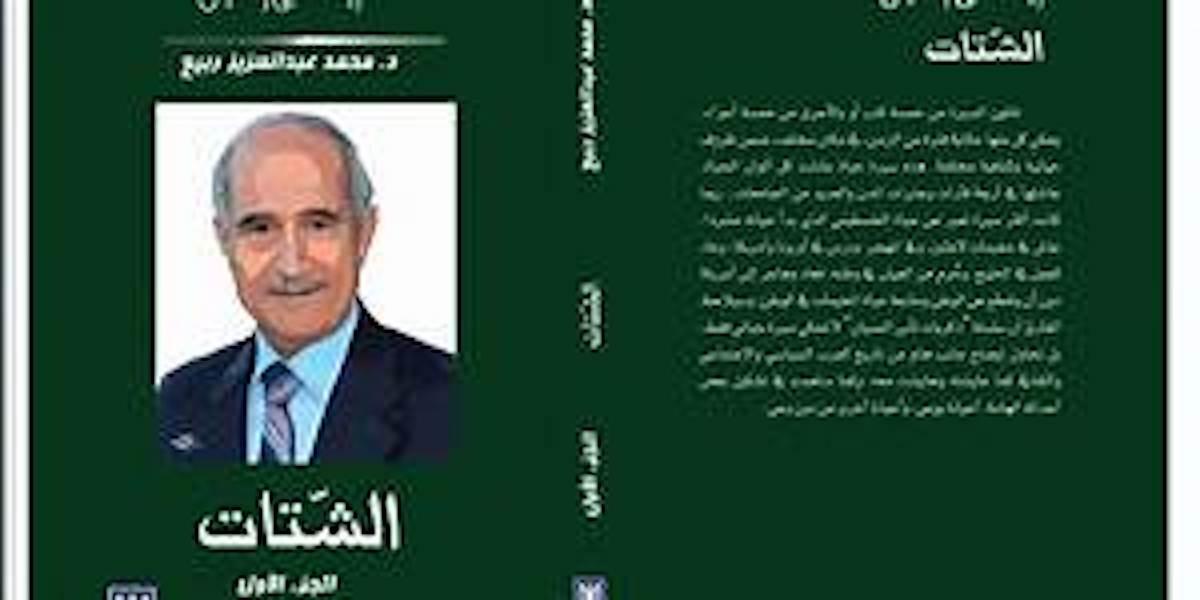
من التراث الشعبي
شهد مقام الإمام علي العديد من الأحداث الغريبة والهامة التي كان لها أثر في حياة أهالي يازور وتراثهم الاجتماعي، من بينها إجراء مراسم جنازة لأحد سكان القرية دون أن يفارق الحياة. لقد وقع ذلك الحادث، كما قالت لي جدتي حِسٍنْ، في السنوات الأولى من القرن العشرين حين كانت صبية، وقبل أن تلد ابنها الأول. كان الرجل الذي شيعوا جنازته مريضاً، ودخل على ما يبدو في غيبوبة دامت يومين، ما جعل نبضه يضعف كثيراً. ظن أهله والمقربون منه أنه فارق الحياة، وبالتالي قاموا بتغسيله وتكفينه وأخذه إلى مقام الإمام علي والصلاة عليه، لكن حين انتهت تلك المراسم كان الوقت قد أصبح متأخراً لدفنه، كانت الشمس على وشك الغروب، ما حتم الانتظار حتى صباح اليوم التالي لحمله إلى مثواه الأخير. ترك المصلون الرجل، أو جثته كما ظنوا داخل مبنى الجامع وعادوا إلى بيوتهم. لكن حين بدأ نور الصباح يتسلل إلى داخل المقام، صحا الرجل من غيبوبته، نظر حوله فوجد نفسه ملفوفاً بكفن ومستلقياً داخل نعش. ذُهل الرجل، لكنه سرعان ما أدرك ما حدث وعرف أنه هناك في انتظار شروق الشمس ليدفن حياً. سارع الرجل إلى الخروج من النعش، فتح باب الجامع، وسار في اتجاه بيته مسرعاً. لكن مروره في شوارع القرية صادف ذهاب المزارعين إلى مزارعهم، وذهاب بعض النساء إلى آبار الماء لملء جرارهن. فوجئ الناس بمنظر شيء غريب يمر في أزقة القرية ملفوفاً في كفن أبيض... ظنوه شبحاً غازياً يريد إيذاء الناس وخطف الأطفال من أحضان أمهاتهم، ما جعلهم يصيحون خوفاً ويتراكضون في كل حدب وصوب، وحتى بعد أن عرف الناس حقيقة ما حدث وتفاصيل القصة، وأدركوا أن حدوثها كان ممكناً ولم يكن معجزة، إلا أنهم شعروا بأن هناك شيئاً يقلقهم في ذلك الرجل، ما جعل البعض من الناس يقرر الابتعاد عنه. نتيجة لذلك أصبح الرجل المسكين شخصاً منبوذاً إلى حد كبير، يخافه الناس، ولا يشعرون بالارتياح إليه أو الرغبة في الاقتراب منه.
من الحكايات الطريفة الأخرى التي وقعت في قرية يازور، حكاية الحمير الثلاثة التي كشفتْ عن جريمة قتل بعد مرور سنوات على وقوعها... جريمة مروعة لم تستطع أجهزة البوليس والمخابرات البريطانية اكتشافها. إذ فيما كان ثلاثة إخوة يقودون حميرهم المحملة بالقمح في طريقهم من يازور إلى قرية ساكيه، اعترضت طريقهم عصابة من قطاع الطرق المسلحين، قام أفراد العصابة بقتل الرجال ودفنهم والاستيلاء على حميرهم وما كان عليها من حمولة. حزن أهل القرية على فقدان الشباب حزناً شديداً، وشاركهم أهل قرية ساكيه الحداد، وتبرع العديد من أبناء القريتين بتشكيل فريق عمل مشترك للبحث عن الجناة والانتقام منهم، لكن كل الجهود، بما في ذلك جهود قوات البوليس البريطاني وجهاز مخابراته باءت بالفشل. بعد مرور بضع سنوات، وكانت الحياة قد عادت إلى بيت عائلة الضحايا إلى ما كانت عليه في الماضي، دق باب البيت طارق غريب بطريقة غير مألوفة. فتحت والدة الضحايا الباب، فإذا بالحمير الثلاثة تقف أمامها وعلى ظهورها حمولة من القمح، وكان التعب والإرهاق والعطش يبدو واضحاً على وجوهها. تعرفت المرأة على الحمير في الحال، أدخلتها إلى البيت وعانقتها بحرارة، ربتت على ظهورها الواحد تلو الآخر حتى اطمأنت الحمير تماماً، ثم أحضرت لها الماء والشعير، وتركتها تأكل وتشرب وترتاح.
جاءت عودة الحمير إلى البيت بعد سنوات غياب مفاجأة أقرب إلى الخيال من الحقيقة، إن لم نقل معجزة. لكن ما كاد أهل البيت يصحون من وقع المفاجأة حتى دق بابهم زوار غرباء، فتحت المرأة الباب، فإذا بالزوار يسألون عن حميرهم، وعما إذا كانت الحمير موجودة لديهم. قالت لهم السيدة بأدب: نعم... الحمير هنا، لقد أكلت وشربت وأنها تأخذ الآن قسطا من الراحة... تفضلوا استريحوا قليلاً، سأحضر لكم الشاي حتى تنتهي الحمير من استراحتها. وبعد أن جلس الزوار على بساط في ساحة البيت مطمئنين، دخلت السيدة إحدى الغرف، حيث أمرت أحفادها بالذهاب إلى بيوت الأهل والأقارب وإعلامهم بأن قتلة شبابهم وإخوتهم في البيت. لم تمضِ دقائق حتى كان حوالي عشرة من رجال العائلة والجيران قد تجمعوا وألقوا القبض على الزوار وقاموا بتقييد أيديهم وأرجلهم وبالتالي تحويلهم إلى رهائن. صُعق الزوار... لم يتعودوا على ذلك النوع من الضيافة، خاصة في يازور التي عُرف عن أهلها الكرم والتسامح واستضافة الغرباء ومد يد العون للمحتاجين منهم. وحين بدأ أهل الضحايا باستجواب ضيوفهم، قال الرهائن إنهم لم يقوموا بقتل أي إنسان، ولا يعرفون عن الحادثة شيئاً، وإنهم اشتروا الحمير قبل سنة في سوق غزة من رجل من أبناء المنطقة يعرفونه جيداً ويعرفون اسمه وبيته حق المعرفة.
إن كون يازور قرية مضيافة على أبواب مدينة يافا، جعلها تغدو محطة يتوقف فيها المسافرون إلى المدينة لأخذ قسط من الراحة قبل دخول سوق المدينة الكبيرة والضياع في زحمتها، خاصة التجار من الفلاحين الذين كانوا يقصدون يافا مشياً على الأقدام أو بصحبة حميرهم أو بغالهم أو جمالهم المحملة بالبضائع. وحين وصل زوار يازور بحميرهم الثلاثة في ذلك اليوم، قرروا التوقف هناك كالعادة بعض الوقت، استلقوا تحت شجرة جميز كبيرة، وتركوا حميرهم ترعى طليقة. لكن الحمير لاحظت أن المكان كان مألوفاً بالنسبة لها، لذلك تحركت في الاتجاه الذي سلكته في الماضي مراراً وصولاً إلى بيت أصحابها الأصليين. بعد أن صحا الزوار من غفوتهم لم يجدوا الحمير حيث تركوها، ما دفعهم للبدء في البحث عنها بسؤال كل من مر بهم أو قابلهم من أهل البلدة. وبالفعل، استطاع أحد الشبان أن يأخذهم إلى مكانها، وذلك لأنه كان قد رأى الحمير تدخل بيت أصحابها الأصليين.
كان أهل الضحايا وجيرانهم وأصدقاؤهم الذين تواردوا على البيت لإلقاء القبض على "القتلة" في ذلك اليوم حكماء، تحلوا بالصبر حتى لا يظلموا أحداً. وهذا دفعهم لإعلام الجهات الأمنية بدلاً من اللجوء إلى قتل الرهائن والانتقام لثأر قديم. وبالفعل، تم تسليم الرهائن للجهات الأمنية الحكومية، حيث قاموا بتزويد البوليس باسم وعنوان الشخص الذي باعهم الحمير في غزة. وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف الرجل باشتراكه في ارتكاب جريمة القتل، كما اعترف بأسماء شركائه، حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعاً ومحاكمتهم وإعدامهم. كان كل ذلك يجري دون علم الحمير، ومن دون أن تدري أنها فعلت ما لم تستطع قوات الأمن والمخابرات البريطانية أن تقوم به، وأنه بدونها ما كان من الممكن أن يتم القبض على الجناة ومحاكمتهم وتطبيق العدالة بحقهم، ولو بعد حين.
من الأحداث الأخرى التي تذكرتها بينما كنت أتعبد في رحاب الطبيعة في غابات جاتلنبيرج، حفلة زفاف عمي إلى ابنة عمه "رحمة" التي كانت امرأة جميلة ومتحررة بكل مقاييس عصرها، وذات شخصية قوية. لقد أحبتني كثيراً على الرغم من خلافاتها الصبيانية مع والدتي أحياناً، وأحببتها أكثر وقدمت لها خدمات كثيرة في طفولتي وصباي. بدأت الزفة من بيتنا، بيت العريس، وخرجت منه إلى مقام الإمام علي في أطراف القرية القديمة، حيث توقفت هناك طويلاً قبل العودة إلى بيت العريس مروراً بالشارع الرئيسي. كانت خالة والدي، "الحاجة عائشة"، تحملني على كتفيها، وكان ابن عم والدي والأخ الأكبر للعروس، العم أحمد إسماعيل، يدق الطبلة طوال الزفة. وفي ليلة الفرح، المسماة ليلة الحنة، كنت الطفل الوحيد من عائلة العروسين الذي رفض أن يضع الحنة في يديه، وكأن التمرد على التقاليد ولد معي كجزء من جينات ورثتها عن أجداد قدامى لم يعد يتذكرهم تاريخ.
وفي صباح اليوم التالي، صحت العروس من نومها متأخرة لتجدني أتسلق شجرة تين عجوز ولكن مثمرة، ومن أجل عينيها الجميلتين حاولت أن اقطف لها أفضل ما كان على الشجرة من ثمار يانعة. كانت تلك الثمار تتدلى من أطرف غصن طري، ما كدت أن ألمسه حتى هوى الفرع الذي كنت أقف عليه وسقطت على الأرض، ما تسبب في فتح جرح عميق في رأسي، استوجب نقلي في الحال إلى يافا، وإجراء عملية جراحية لوقف النزيف وإغلاق الجرح. وعلى الرغم من شفاء الجرح تماماً بعد أيام، إلا أن آثاره أبت أن تزول، حيث تركت في وسط رأسي شبه أخدود دائم، بدأت معالمه تتكشف للعيان قبل سنوات حين لم يعد في الرأس ما يكفي من الشعر لإخفاء ما تحته من آثار شقاوة قديمة. مع ذلك لم أتوقف عن تسلق شجرة التين أو غيرها، لكنني تعملت من تلك التجربة القاسية، ولذا لم أقع من فوق شجرة بعد تلك الحادثة.
وفي يافا، تلك المدينة الجميلة التي أطلق عليها الفلسطينيون لقب "عروس البحر" تعرضتُ لعلاج على يد "طبيب" عيون لم يكن يعرف من الطب أو عن الطب شيئاً تقريبا... لم يكن ذلك الشخص في الواقع طبيباً كما علمت بعد أن أصبحت شاباً خلال إحدى زياراتي لمدينة رام الله، بل كان ممرضا على معرفة ببعض الأمراض المتعلقة بالعيون. كان "الدكتور الجبجي" يعطيني قطرة عين حارقة مرتين كل أسبوع، يستمر مفعولها المؤلم لساعتين تقريباً، وذلك لعلاج بقعة صغيرة على بؤبؤ عيني اليمنى كنت قد ورثتها مع ما ورثت من جينات عن أجدادي. لكن حرص العبد أبو ربيع على صحة أولاده دفعه لبذل ما لديه من جهد لعلاج تلك البقعة والعمل على إزالتها. وفي ضوء بكائي الشديد بعد كل زيارة لعيادة الدكتور الجبجي، واستمرار البقعة على حالها، أخذني الوالد لزيارة عيادة الطبيب الذي كان يعرفه شخصياً ويثق به كثيراً، الدكتور زهدي الدجاني، مع أن الدكتور الدجاني لم يكن متخصصاً في طب العيون. بعد إجراء الفحص والتأكد من حالة عيني، قال الدكتور إن البقعة شيء بسيط، كثيراً ما يحدث للأطفال في سني، وأن من المؤكد أن تزول تلقائيا حين أبلغ الخامسة أو السادسة من العمر، لذا لم يكن هناك داع للقلق. وبالفعل زالت البقعة من دون علاج، واختفى أثرها قبل أن نغادر يازور الحبيبة، لكن العين على ما يبدو تأثرت سلباً ولكن قليلاً بالعلاج.
إن اهتمام العبد أبو ربيع بالنواحي الصحية دفعه أيضاً، تحت تأثير بعض أصدقائه من الرهبان المسيحيين الذين علموه صنع النبيذ، إلى إضافة ملعقة من النبيذ الأحمر لكأس الحليب الذي كانت تعده لنا الوالدة كل صباح، خاصة في فصل الشتاء، لاعتقاده بأن النبيذ يبعث الدفء في جسم الإنسان ويزيده حيوية. كان والدي يشترى العنب ويعصره بيديه، ثم يضعه في زجاجات خضراء اللون ويدفنها في البيارة، وكان يأخذني معه كلما أراد أن يحضر زجاجة جديدة من تحت الأرض. كانت هذه بعض الذكريات التي عادت إلى الذهن مع عودة الوعي بعد أكثر من عشرين سنة على وقوعها. لم أر والدي يتناول الكحول في حياته، ولا أعتقد أنه جربها، ولذا كان يشعر بالإحراج كلما ذكرته بما كان يفعل معنا بالنسبة لكأس حليب الصباح المخلوط بالنبيذ المعتق في أيام الصغر.
كان الرهبان قد أقنعوه أيضاً بأن يسجلني في مدرسة الفرير في يافا باعتبارها مدرسة نموذجية، وبالفعل أخذني الوالد إلى المدرسة وسجلني بعد أن أبديت إعجابي بها وبزي التلاميذ فيها. إلا أن الرياح كانت تجري بما لم تكن تشتهي السفن، حيث توقفت الدراسة في كل مدارس يافا قبل بداية السنة الدراسية الجديدة، وذلك لبدء عمليات الإرهاب والتطهير العرقي التي شنتها العصابات اليهودية بدءا من أوائل عام 1947. لقد كانت حكاية النبيذ أهم سلاح استخدمته مع والدي خلال فترة شبابي، إذ كلما حاول الضغط علي بسبب عدم التزامي بالطقوس الدينية كما يجب، كنت أذكره بتلك الحادثة، يخجل ويحمر وجهه، ثم يلوذ بالصمت، وننتقل إلى موضوع آخر.
اتصفتْ أيام الحكم التركي بالقسوة والتخلف والتسلط، ما جعل البلاد العربية تشهد خلالها جمودا فكرياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً كبيراً حال دون تقدم الشعوب العربية وتحررها، واسهم في تكريس حالة التخلف التي كانت تعاني منها البلاد العربية والإسلامية عامة. وعلى سبيل المثال، لم تفتح السلطات التركية مدرسة في أية قرية من قرى الساحل الفلسطيني خلال فترة حكمها لتلك البلاد، إذ كان على أطفال يازور وغيرهم الانتظار حتى عام 1920 للالتحاق بالمدارس، ما حرم جيل العبد أبو ربيع بكامله تقريباً من الدراسة. وفي ظل سيادة الجهل وجهالة الحكم، وتحكم رجال دجالين أو أميين أو طامعين أو مُغرر بهم في إدارة الشؤون العامة، فإن المجتمع الفلسطيني شهد انتشار الكثير من الخرافات بين عامة الناس وترسخها في وعيهم كمكون أساسي من تراثهم الشعبي وتقاليدهم وثقافاتهم. على الرغم من ذلك، كان للحكم التركي جانب إيجابي ثانوي، لكن مهما بالنسبة لعامة الفلسطينيين، إذ اعتبر المرأة المتزوجة من رجل غريب عنها وتعيش معه بعيداً عن أهلها وقريتها بحاجة لحماية، وبالتالي بحاجة لبقاء زوجها إلى جانبها، ما استوجب إعفاء زوج المرأة الغريبة من الخدمة العسكرية. في ضوء ذلك، اتجه الكثير من شباب يازور وغيرهم إلى الزواج من قرى قريبة أو بعيدة نسبياً، وبالتالي تجنب الخدمة العسكرية في جيش كانوا يكرهون الخدمة فيه، وكثيراً ما كان يُستخدم أداة لكبت حركة التنوير الفكرية والثقافية في بلادهم.
وفي يازور، قام العديد من رجال البلدة بالاقتران بنساء من قرى مجاورة مثل "سلمه" وبيت دجن، "والشيخ مونس"، وبعيدة نسبياً مثل قلقيلية والطيرة، وبعيدة جداً مثل جزيرة قبرص. فعلى سبيل المثال، تزوج أكثر من شخص من حمولتنا، حمولة "الحوامده"، من قرى قلقيلية وسلمه والخيريه، وتزوج جدي من الشيخ مونس التي ربما كانت أجمل قرى فلسطين الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. كانت تلك القرية الوديعة تصحو في الفجر على صوت البحر يناديها كي تستيقظ من سباتها، وتغفو حين يتقادم الليل على همسات نسماته العليلة تُهدهدها كي تنام مطمئنة وتحلم أحلاماً سعيدة. وحين احتلها الصهاينة قاموا بإزالة آثارها وتشييد جامعة تل أبيب على أنقاض ذكرياتي والقلاع الهشة التي بنيتها بأصابعي الطرية على شواطئها. هناك على شواطئ الشيخ مُونس، وأمام مقهى خال والدي "حسين القنيري"، شيَدتُ أول قلعة في طفولتي التي صادرها الصهاينة في عام 1948. ومع توسع عمليات التزاوج بين أبناء المدن والقرى الفلسطينية المختلفة، أصبح الشعب الفلسطيني عبارة عن شبكة إنسانية وثقافية واحدة، تشد أعضاءها بعضهم إلى بعض علاقات نسب وقرابة وجوار، وتوحدهم تجارب كفاح وأيام دراسة وسجون مشتركة. وفي أعقاب قيام العصابات الإرهابية بتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من ديارهم ونفيهم بين عامي 1947 و 1948، وجد مئات الآلاف من الفلسطينيين أنفسهم يعيشون في مخيمات لاجئين على أطراف المدن الفلسطينية الرئيسية مثل نابلس ورام الله والقدس والخليل وبيت لحم وأريحا وغزة ورفح، وهذه مدن تقع فيما يعرف اليوم بالضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا اسهم بدوره في تعميق روابط النسب والجوار والثقافة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وقام بتقوية عرى التماسك والوحدة فيما بينهم.

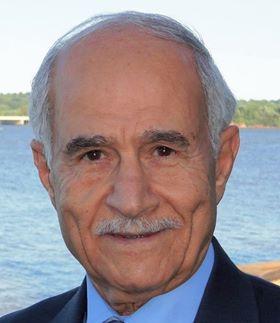
إضافة تعليق جديد