البروفيسور محمد ربيع يكتب : الاحتفال بالهجرة النبويه
إن الكلمات التي نستعملها تعكس عادة ما نفكر به من أمور حيوية، وما نعتقد بأنه يجسد حقيقة مؤكدة في العالم الذي نراه ونعيش فيه. لكن ما يغيب عن بال كل مؤمن أن ما يراه لا يمثل الحقيقة كما هي بالفعل، وإنما جزءا منها قد يكون جوهريا وقد يكون هامشيا، وأن ما يراه غيره من الناس من الشيء نفسه يمثل جزءا مختلفا من نفس الحقيقة، وأنه ليس بإمكان إنسان أن يرى الحقيقة كامله. لذلك حين يدرك المومن حقيقة هذا الأمر، ويفكر في أبعاده وتبعاته، فإنه يشعر بالدهشة، وأحيانا الارتباك. وهذا يقود بعض المؤمنين إلى الانغماس في الإيمان أكثر، ما يجعل المؤمن يتحول إلى إنسان يسير مغمض العينين كي يحافظ على توازنه ويتحاشى ما في رأسه من علوم وأفكار قد تعكس حقيقة مؤكدة؛ ويقود البعض الآخر إلى الخروج من دائرة الإيمان بحثا عن تفسير لهذه الظاهرة المثيرة، فيما يقود الكثير إلى الدخول في حالة هلوسة فكرية تتسبب في اختلال توازنهم النفسي، وازدواجية مواقفهم من كل شيء تقريباً، بما في ذلك الإيمان وما يدعو إليه من أخلاقيات ومبادئ وقيم.
نتيجة لهذه الأحداث، أصبح بالإمكان تطوير فلسفة اجتماعية ثقافية مرنة انبثق عنها ميلاد طرق تفكير عقلانية اتجهت إلى التركيز على الحاضر والمستقبل، بدلا من التركيز على الماضي وتركته التراثية. ولقد جاءت تلك الفلسفة بلباس علماني، ما جعلها ترفض الادعاء الكهنوتي بأن الدين يملك الحقيقة دون غيره من مصادر أرضية، والقول في المقابل بأن الحقيقة مُلكٌ لجميع البشر، وأنها حقيقة علمية وليست غيبية، تنتجها البشرية باستخدام ملكاتها العقلية، وإتباع منهج علمي في البحث والتحليل والتفكير؛ وهذه نشاطات تسعى للتعرف على القوانين التي تتحكم في حركة الكون وما به من كواكب ونجوم وغير ذلك، واستنباط النتائج. ولما كانت ظروف كل عصر وأنماط إنتاجه الاقتصادية، ومكونات ثقافته، وحصيلة ما لديه من معارف علمية تتغير من مكان لآخر ومن وقت لآخر، فإن الحقيقة نفسها أصبحت عرضة للتغير؛ الأمر الذي جعل الثوابت العقائدية والتركات التراثية تصبح موضع شك، وتفقد جزءا من مصداقيتها. لذلك نلاحظ أنه مع كل تقدم في العلم والاقتصاد والفكر، تتراجع أهمية التراث في حياة المجتمع، ومع تخلف كل مجتمع عن العصر يزداد تركيزه على تراثه الغابر، وكأن التراث بديل للواقع، والتغني بالماضي ملهاة لنسيان الحاضر وتجاوز التخلف واللحاق بالعصر.
وهذا يعني أن الكثير من الحقائق العلمية ومعظم النظم الاجتماعية والتقاليد الثقافية والقيم تنتهي صلاحيتها مع كل طفرة حضارية، ما يجعل من طبيعة الحقيقة أنها تتغير وتتطور باستمرار. وتأتي كل طفرة حضارية حين يتمكن الإنسان من تطوير نمط إنتاج اقتصادي جديد يختلف عن النمط السائد ويتجاوزه من حيث القدرة على الإنتاج، والتوصل إلى معلومات تكشف عن حقائق جديدة لم تكن معروفة من قبل تتعلق بالطبيعة والكون والحياة والتكنولوجيا. وهذا ما حدث في أوروبا إبان فترة انتقالها من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة، إذ وجد الإنسان الأوروبي نفسه يتحرك بحرية في المكان والزمان في آن واحد. ومع الأيام تسارعت حركة التطور بسبب تراكم المعارف العلمية والفنون التكنولوجية ورأس المال، وابتعاد الإنسان عن الغيب والغيبية، واتجاهه إلى استخدام العقل والمنطق منهجا في التفكير، والاعتماد على العلم والتجربة الإنسانية مرجعاً أساسياً للحكم على قيمة الأشياء ومصداقية الادعاءات المختلفة. وبالتدريج، أخذ المال والمصلحة الاقتصادية تطغى على ثقافات المجتمعات الصناعية عامة والعلاقات الاجتماعية والإنسانية فيها، فيما كانت تلك المجتمعات تتجه نحو تبني مفاهيم الحرية الاجتماعية والفكرية، والتعددية الدينية والثقافية والسياسية. وهذا مهد الطريق لظهور الاتحادات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والتحول تدريجيا نحو الديمقراطية بشقيها السياسي والثقافي.
وفي ضوء احتفال المسلمين هذه الأيام بعيد الهجرة النبوية من مكة إلى المدنية، نرى أنه من المفيد أن نلقي نظرة سريعة على هذا الحدث الهام، وأثره على تفكير المؤمنين. إن الاحتفال بهذا العيد، شأنه شأن الاحتفال بمولد الرسول ومولد المسيح، هو حدث لا يعرف أحد من البشر اليوم الذي وقع فيه، ولا يستطيع علم تحديده. إذ جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث منسوب إلى أنس بن مالك يقول أن الرسول مكث في مكة 10 سنوات بعد بدء الدعوة إلى الإسلام، ومكث 10 سنوات أخرى في نشر الدعوة بعد الهجرة إلى المدينة، وأنه توفي وعنده 60 سنة. وهذا طبعا يخالف المتعارف عليه، وهو أن الرسول مكث في مكة 13 سنة ينشر الدعوة، وبعدها هاجر إلى المدينة، وهناك استمر 10 سنوات أخرى يدعو إلى الإسلام، ما يعني أنه توفي وعنده 63 سنة. من ناحية ثانية، تقول كتب التراث أن الرسول ولد عام 571 ميلادية، وأنه والده توفي عام 570، أي قبل مولده بسنة، وهذا طبعا غير ممكن لأن مدة الحمل هي 9 أشهر فقط، وأن أمه توفيت عام 576، أي حين كان عمر الرسول 5 سنوات، وجده توفي عام 578، أي حين كان عمر الرسول 7 سنوات، فتولى عمه أبو طالب رعايته. وهناك ادعاءات تحدد يوم ميلاد الرسول ويوم نزول الوحي عليه لأول مرة، ويوم وفاته بيوم واحد هو 12 ربيع الأول. لكن احتمال وقوع هذه الأحداث المتباعدة في يوم واحد من شهر ربيع الأول ربما يقل عن الواحد في المليار. فإذا كان هناك خلاف حول عمر الرسول وسنة الهجرة، وليس يومها، فكيف يمكن معرفة يوم ميلاد صبي يتيم في عصر ساده الجهل وعدم الاكتراث بالمواعيد، فالبدوي لا يعرف عمره ولا تاريخ ميلاده. وهذا يعني أن الله تدخل في الأمور هذه ليكون التوافق برهانا على النبوة؛ الأمر الذي يجعل "المعجزة" هي الحقيقة الوحيدة وأصدق من كل علم، علما بأن هذه المعجزة وغيرها لا يستطيع إنسان أن يثبتها.
ليس هناك عيب في قيام شعب بالاحتفال بحدث هام يعتز به، إذ بإمكان الدولة أن تحدد يوما للاحتفال بالحدث المعني، وهذا يجعل الجهة المعنية تأخذ مختلف الخيارات في الاعتبار. أما تحديد يوم يقوم على ادعاء بأنه اليوم الحقيقي لوقوع حدث قبل أكثر من 1400 سنة، فهذا تصرف لا يجوز القبول به إطلاقا، لأنه لا يمكن إثبات صحة الادعاء المعني. الأمر الذي يجعل مثل هذا التصرف يتجاوز العقل والمنطق، ويخالف العلم باللجوء إلى الكذب والتزوير ومنح الكذب قدسية. إن عملا كهذا لا يخدم سوى هدف تزييف وعي المؤمن وإغلاق عقله، باعتبار التوافق في المواعيد معجزة إلهية. وما دام هذا التوافق معجزة إلهية، فإن الشك في صحتها يصبح خروجا على الدين. وهكذا يتم تزييف المواعيد وإلزام المؤمن بها، لأن الإيمان يقوم على حتميات يتكفل الله بها، ويجعل المؤمن مجرد آلة تتحرك بناء على عقل مسير عاجز عن التفكير. علينا أن ندرك أنه "لا علم في الدين، ولا دين في العلم"، وكل ما يخالف هذه الحقيقة يقوم على الكذب والتزوير وخداع المؤمنين.
بروفسور محمد عبد العزيز ربيع

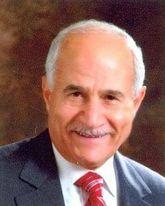
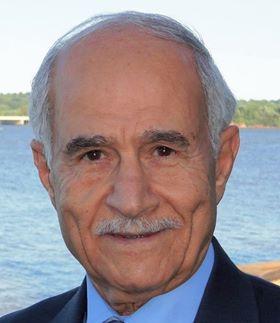
إضافة تعليق جديد